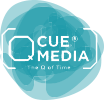"الإلتقاط" كـ "نقطة صفر"

محمود عبد اللطيف
يبدو أن وصف "لقيط"، الذي يأتي من فعل "لَقَطَ"، يأخذ معناه السلبي مجتمعياً، لكون صاحب هذا اللقب هو الذي تحمل وزر عاشقين، أو عابثين في لحظة ما، وقد يكون نتاج ظرف مجتمعي قذف بأنثى ما في درب التقطها منه "قواد" ما، ليضع رجلها على أول درب "الخطيئة"، رغم إني أعرف - أو سمعت- عن سيدة كانت تستمع بخطيئتها، وتعتبر المقابل المادي الذي تلتقطه من زبونها، تعويضاً جزئياً عما قدمته له من متعة، وأعرف - أو سمعت- عن أخرى أجبرها الجوع على أن تأكل من لحمها، ثم إنها ألتقطت قناعة بأن ما تمتلكه من مفاتن ومغريات، بضاعة ستجعلها دورة الزمن كاسدة ذات يوم، وبتشبيه أدق "بضاعة لزمن مضى"، وعلى هذا الأساس أخذت تكتنز ما تستطيع من مال لتحظى بتقاعد مريح في مدينة أخرى لا تعرف فيها أحد، وهناك ستكون ما تشتهي، وبالطريقة التي تشتهي، إذ أن ذاكرتها ستكون حبيسة صدرها وحسب.
تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأطفال حديثي الولادة وجدوا في "حاوية قمامة"، أو أمام باب دار للعبادة، يلتقطها البعض من باب البحث عن ذوي الطفل علهم يشفقون عليه من لقب "لقيط"، وآخرون يبحثون عمن يكون جاهزاً لحمل ثقل أمانة رعاية مثل هذا الطفل وإن عبر دار لرعاية الأيتام، وسأكون متفائل حين اعتبر أن قلة ممن يلتقطون هذه الصور يكون هدفهم "اللايكات والتفاعل"، وعلى أساسس زيادة عدد من سنعتبرهم بلا أصل واقل منا في سلم الإنسانية بكونهم" لقطاء"، بات من الواجب أن يكون ثمة قانون ينظم حياتهم ويحميها بشكل جدي، ويمنحهم هوية وشيء من ذاكرة.. فالاستمرار بتحريم "التبني"، دينياً بحجة الحفاظ على النسب يحتاج للتأمل في وقتنا الحاضر، فكيف سنتعامل مع "مجهول النسب"، وكيف سنعطيه اسماً ثلاثياً يحتاجه قانوناً في كل مؤسسات الدولة بما فيها المدرسة، إن كان منحه اسم "أب"، و "أم"، و "كنية"، محرم دينياً.. ماذا سيقول لمعلمة الصف الأول حين ستذهب نحو سؤاله "شو بيشتغل بابا"، وكيف سيتلقط إجابة من زحام إجابات أقرانه في الصف إن كان ممنوعاً عليه ذلك بعرف ديني تخلى رجاله فجأة عن "الاجتهاد"، وقرروا أن يتركوا هذا "اللقيط"، لمجهول آخر يلتقطه ليضعه في صندوق او زنزانة أو احتمال ثالث ربما يكون قبراً.
حين مرور هذه الفكرة في رأسي، كان ثمة شاب يلتقط صورة "سيلفي"، مع حبيبته على الرصيف المقابل، محاولاً توثيق لحظة ما، تذكرت حينها الطريقة القديمة التي كنا نشتري فيها "فيلماً"، للكاميرا الـ ٢٤ أو الـ ٣٦، وكيف نحرص على جعل البائع هو من يقوم بتركيب "الفيلم"، وإخراجه بعد التصوير كي لا "يحترق"، فيضيع ما التقطانه من صور نخزنها في "ألبوم"، سيكون في زمن آت كصندوق الكنز الذي بحث عنه "جيم"، و "سيلفار"، في رحلتهما نحو الجزيرة، وحين كبرنا اكتشفنا أن عكاز القرصان "سيلفار"، لم يكن سوى مجموعة من الذكريات والأحلام التي اتكأ عليها في رحلته الشاقة ليلتقط في آخرها بعضا من الأيام المريحة، هنا لنتخيل أن تكون في زمن الفوتوغراف بعهده الماضي، وتعود من مهمة صحفية بفيلم صور "محروق"، أي وجع كنت ستحس به، وما هي البدائل التي كنت ستؤمنها في زمن كان فيه الانترنيت رفاهية مكلفة جداً، ولا يعرفها إلا قلة من الناس..؟، أو لنتخيل كم ستكون مهنة التصوير الفوتوغرافي أو الضؤي محصورة بقلة من الناس، فلا كاميرات ديجتال، ولا فوتوشوب يعطيك "فلاتر" و" إفكيت"، لتصبح نجما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في رحلة إلى البحر جمعتني وثلة من الأصدقاء، سخر مني صديق حين "لقطني" افتش عن الصدف لألتقطه من على الشاطئ كذكرى للرحلة، وقال ساخراً أو ممازحاً: «لما تتعب بالتقاط الصدف وبإمكانك شراء الكمية التي تريد من المحال أو البسطات التي تبيع كل ما يخطر ببالك ليكون ذكرى من تلك المدينة الساحلية».
وهذا يفرض سؤال كبير.. كيف تباع الذاكرة..؟ ، وهل قطفوا الصدف من شجرة ما كأي ثمر يزرعونه أم التقطوه من الشاطئ، وكيف يتحول التقاط الذكريات لمهنة"، قد يبدو التساؤل هنا كفكرة فلسفية زائدة الدهون والسكريات.
هربت من سخرية صديقي لأراقب صيادا يرمي بسنارته إلى البحر لينتظر سمكة ما، للآمانة كان مشدوها بتكرار التقاطه للدود التي يصير" طعماً"، يرميه للسمكة التي سيتلقطها مخلب حديدي يحيلها لاحقاً إلى وجبة دسمة، ولا أدري ما الذي جعلني أقارن بين صبر الصياد الهاوي الذي لا يحتاج إلى جهد في غالب الأحيان، مع صبر الصياد الذي يبذل حهدا بالتجديف ويقامر بحياته في صراع مع البحر أو النهر ليرمي بشباكه منتظرا امتلائها بالسمك الذي سيلتقطه لاحقاً ليكون بضاعة تباع في سوق كبيرة، أيضاً قارنت بين صبر كلا الصيادين مع آخر يغوص به الفلاح الذي يجهد في حراثة وبذر وتسميد ويصلي لهطول المطر حينما يمارسه الصبر مفعولاً به حتى موسم الحصاد الذي قد لا يكتمل وإن كانت سنة خير وفقا للتعبير للشعبي.
لنعد لـ "الالتقاط"، وما كنت أريده من هذه الكلمة التي تعد لغويا وفقا لمعرفتي "مصدر سداسي"، وقد أكون مخطئاً فمنذ أمد لم أطالع أي كتاب في علم اللغة العربية مثل "جامع الدروس العربية"، وتحولت من شخص كان ينال الدرجة التامة في أي امتحان لمادة "العربي"، في سنواته الدراسية لآخر يمكن أن يقع في كثير من المطبات اللغوية والنحوية وحتى الإملائية فيما يخص كتابة بعض الهمزات والحركات، وإذا ما راجعت نصي هذا ستجد أخطاءً بالتأكيد.
أبرر ذلك لنفسي بأن مدققا لغوياً سيمر على ما أكتبه للصحافة، وسيعتبر أن زبدة المعلومة الدسمة هي من دفعت بأصابعي نحو "زلق مطبعي"، وقد اتفقت في هكا النص تحديداً معه على عدم التدقيق، ليلتقط القارئ كل خطأ وقعت فيه عن غير قصد أو مع.
ولا أخفي سراً حين أقول أن وجود المدقق يشجعني على مواصلة إلتقاط بعض الأفكار التي تكون مرمية على رصيف الرؤية كنتاج لفعل ما، قد يكون عفوياً أو غير ذلك، وقد يكون هداماً أو غير ذلك، وبعد إلتقاط الفكرة، أمارس فيها فعل التبني، فأنظفها من كل الرواسب العالقة على وجهها الجميل، أغسلها ببعض من ماء السؤال، لتصبح ناصعة، ثم أمارس فعل التهذيب بالكتابة، حتى تصبح مقالاً أفرح به كأب يرى طفلته قد غدت عروساً مزهوة بفستانها الأبيض، ثم يبدأ بالتقاط ما تسعفه به الذاكرة من صور ليوم عرسه.. وربما أبعد.
الإلتقاط، هو أولى خطوات امتلاك فنون الصحافة، وبه يلتقط الموضوع من بين مجموع حكايا المجتمع، وبه ألتقط الصورة، ومنه استخرج مفاتيح نجاح مادة، وعلى الصحفي - أكاديمي أم لا- أن يشارك في بناء حقيقة وواقع أفضل، وهذه الملكة - الإلتقاط - لا يمكن تدريسها أو صنعها في الشخص من خلال التعليم، لكن يمكن صقلها وتطويرها لدى من وجدت به أساساً.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: