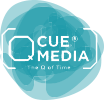تجارب التنمية وتغير الأولويات

د. مدين علي
اتجهت معظم الدول التي نالت الاستقلال منذ مطلع خمسينيات وستينيات القرن الماضي، نحو تنفيذ مجموعة كبيرة من الخطط، والبرامج الاقتصادية التنموية، التي كانت تستهدف آنذاك، نسف جذور التخلف، وضرب مرتكزاته، كمدخل لتغيير الواقع، ودفعه نحو الأفضل.
وبقي السؤال الأبرز في هذا الإطار، أين وصلت هذه الدول، وماهي النتائج، ولماذا أخفقت، وأين نجحت ؟
تؤكد تجارب التنمية المستخلصة من عبر الدروس الاقتصادية في التاريخ، على أنه لا يوجد نموذج اقتصادي معين، يمكن أن يُعمّم، كنموذجٍ أوحد، يُحتذى به للتطبيق، يحمل في طياته ترياق الإنقاذ من التخلف، كحالة اقتصادية واجتماعية وسياسية، كما تؤكد التجارب وفي السياق ذاته أيضاً، أن التنمية، ليست خطوة تُنجز، ولمرة واحدة فقط وتنتهي، بل هي دينامية مستمرة، تستهدف إيقاظ روح الأمة، مع كل دورة تقدم، أو إنجازٍ حضاري، وبالتالي تستهدف إعادة بعث الحياة فيها من جديد، بخصائص معاصرة، وبقدراتٍ نوعية مختلفة، تلبي متطلبات الانعتاق، من إرثٍ تاريخيٍ ثقيل، أوهن كاهلها، وشل أعصابها، وأعاق قدرتها على الحركة نحو إنجاز مشروعها التاريخي.
في ضوء ما تقدم، يتبين لنا بصورةٍ واضحة، أن التنمية كعملية وسيرورة، هي أبعد من أن تكون مجرد عملية تحديث سريع وحسب، تبرز تجلياتها، بواسطة مؤشرات أو مظاهر زائفة، في مختلف المجالات، وفي شتى الميادين، بدءاً من الاقتصاد والاجتماع، مروراً بالتنظيم والعمران، وانتهاءَ بنمط الاستهلاك، (وهو ما وقعت به معظم الدول المتخلفة)، لتكون عملية مركبة شاملة وجذرية، تستهدف إعادة تشكيل منظومة الدولة والمجتمع، وصياغة روح الأمة، وإنتاج مضمونها، برؤى معاصرة، انطلاقاً من عقد اجتماعي جديد ويتجدد بصورةٍ دائمة، يمكن أن يُراهنَ عليه بقوة، في تعبئة الطاقات الإنتاجية والإبداعية لمختلف مكونات المجتمع، بصورةٍ مغايرة، يمكن أن تساعد في تغيير الوجهة، وتصويب المسار، نحو المشروع الحضاري للأمة.
كما أن التنمية، وكما تؤكد دروس التاريخ وعبره، هي أبعد من أن تكون مشروع لأفراد، أو لجماعات وأحزاب، وأبعد من أن تكون من نتاج كتل بشرية غير متجانسة، غالباً ما ينطوي مضمونها، على وعيٍ زائفٍ، ورؤى شعبوية، وخطبٍ غوغائية، مشحونة بدوافع غريزية، دهمائية.
إنها أبعد من كل ما تقدم، لتكون المشروع الأعظم للدولة كإطار كلي، والمضمون الأسمى والأكثر عبقرية، لنخبٍ نبيلة وحرة، محكومة بالإرادة ودافعية الإنجاز، والمشحونة، بطاقاتٍ إيجابية خلاقة ومبدعة، تفيض ذهنيتها بملكات الحس السليم، تمتلك الرؤية العقلانية، ولديها الإحاطة الشاملة والكلية بتفاصيل الواقع، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، يُناط بها مهمات تحديد مسارات مشروع التنمية وبدائلها، ويُلْقى على كاهلها، مهمة إعداد الخطط والبرامج، وآليات الإنفاق وتخصيص الموارد بصورة أكثر عقلانية، تساعد في بناء القاعدة المادية والتقنية الصلبة، والبنية التحتية المتماسكة اللازمة لمشروع التنمية، (وهذا ما لم يحصل في الدول المتخلفة).
تسعى التنمية كسيرورة ومسار نحو تغيير الواقع، ونقل المجتمع نحو الأفضل، وتحسين ظروف حياة الناس، وتوفير كل الشروط التي يمكن أن تساعد في توطيد دعائم الاستقرار، وتثبيت شروط السلم ومتطلبات التوازن الاجتماعي والمجتمعي، بصورة مُستدامة.
تؤكد الوقائع والمؤشرات، على أن تجارب التنمية في معظم الدول المتخلفة، إما أنها أخفقت، وفشلت فشلاً ذريعاً، وانتهت بانفجار النموذج، وإما أنها نجحت نجاحاً محدوداً، وبصورةٍ بسيطةٍ، جعلت نسيج المجتمع، نسيجاً هشاً، قابلاً للتصدع والانكسار، كلما توفر الشروط، التي يمكن أن تساعد، في زيادة درجة الاحتقان، وترفع منسوب التأزم، وكلما قويت شوكة العوامل، التي يمكن أن تساعد، في إشعال فتيل الانفجار الاجتماعي، سواء كانت العوامل الداخلية أو البنيوية، التي تنتجها قوانين المنظومة ذاتها، أو العوامل الخارجية، التي تنتجها، أو تولدها تناقضات المصالح، للقوى الإقليمية والدولية، ويبقى الخاسر الأوحد في كل الحالات، هي الدول المتخلفة ومجتمعاتها، التي تحولت وحُوِلت، إلى دول ومجتمعاتٍ فاشلة، مشغولة بأولويات مختلفة، وتفاصيل بلا مضمون بعيدة عن أولويات التنمية ومتطلباتها.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: